الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ ، وَ لَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ ، وَ لَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ ، وَ هُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ ، فَطَرَ أَجْنَاسَ الْبَدَائِعِ ، وَ أَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلَائِعُ ، وَ لَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ ، فَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، وَ لَا شَيْءَ يَعْدِلُهُ ، وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
والصلاة والسلام على المحمود الأحمد، والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ...
سؤال/ 45: ما معنى قوله تعالى في أول سورة البقرة: ﴿ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب﴾ ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿آلم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ([87]).
اسم الله: هو مدينة الكمالات التي أشرقت وتجلت من حقيقته وهويته سبحانه التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كما أن الرحمن الرحيم وهما متحدان في المعنى يمثلان باب هذه المدينة، وظل هذه المدينـة في عالم الممكنات هو الذي أشرقت في ذاته وتجلت فيه وهو محمد (ص)، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ([88])؛ لأنه تخلق بأخلاق الله، وإلا فلا يستحق خُلق أن يوصف بأنه عظيم إلا إذا كان تجلّياً وظهّوراً لأخلاق الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان محمد (ص) مدينة العلم.
أما باب هذه المدينة فهو علي (ع) ومن اختلط لحمها بلحمه ودمها بدمه فاطمة (ع)، وبهذا فعلي (ع) تجلي للرحمن، وفاطمة (ع) تجلي للرحيم، وهما متحدان كاتحاد الرحمن الرحيم ومفترقان كافتراق الرحمن الرحيم.
﴿أ ل م﴾: قال أمير المؤمنين (ع): (أنا: ح الحواميم، أنا: قسم أ ل م … أنا: ترجمة ص … أنا: ن والقلم) ([89]). وهذه الحروف هي أسماء أهل البيت (ع)، وهنا (م) محمد، و (ل) علي، و (أ) فاطمة وإذا حسبت عدد هذه الحروف وجدتها أربعة عشر على عددهم (ع). وتكرر الميم (17) مرة، واللام (13) مرة، والألف (13) مرة.
ومن هذه الحروف تألف القرآن، وهم (ع) القرآن ([90]). ومن هذه الحروف يؤلف الاسم الأعظم كما روي عنهم (ع) ([91])، وهم الاسم الأعظم كما روي عنهم (ع) أيضاً ([92])، أي تجلي الاسم الأعظم، وما يمكن أن يعرف من الاسم الأعظم، أو قل الاسم الأعظم في عالم الخلق (الممكنات).
وكما أنّ الكتابة تتألف من اختلاط هذه الحروف الأربعة عشر النورانية مع الأربعة عشر الأخرى الظلمانية، كذلك وجود المخلوق (الممكن) يتألف من اختلاط نورهم بالظلمات، أو قل: تجلي أنوارهم في الظلمات.
كما أنهم (ع) يمثلون تجلي نور الله سبحانه وتعالى في الظلمة، وأعني بالظلمة العدم القابل للوجود، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور ٍ﴾ ([93]). فهم (ع) مَثَل نور الله ([94]).
﴿ذَلِكَ الْكِتَاب﴾: ذلك : اسم إشارة للبعيد، وهو هنا إشارة إلى الحروف: (ا ل م) القريبة، فالبعد المراد هنا ليس مكاني بل شأني، فهذه الأسماء المباركة والتي هي كتاب الله أيضاً عالية الشأن رفيعة الدرجة والمقام لا تنال، قال (ص) ما معناه: (يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا) ([95]).
والكتاب: أي كتاب الله الحاوي للعلم وهو محمد (ص) أو الميم، وهو علي أو اللام، وهو فاطمة أو الألف.
ومحمد (ص) هو الكتاب الأتم والكلمة التامة، والأولى بأن يطلق كتاب الله عليه، فالموجودات جميعها منطوية في صفحة وجوده المباركة ومكتوبة فيه، كالكلمات المكتوبة في السجل.
وهو صلوات الله عليه في عالم الخلق الألف والياء، والبداية والنهاية، والظاهر والباطن. وكذلك علي وفاطمة، ولكنه صلوات الله عليه كتاب بلا حجاب، وهما صلوات الله عليهما محجوبان به (ص)عن الذات. فهو المدينة وهما الباب المواجه للخلق ، ومنهما يؤخذ ، ومنهما يفاض على الخلق.
أما الباب الآخر للمدينة والكتاب المواجه للذات الإلهية فهو الرحمن، وبهذا الباب العظيم الرحمة افتتح عالم الخلق أو كما يسميه بعضهم عالم الإمكان، وببركته خلق الإنس والملائكة والجان، وبه يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر الأمر، ولو دبر بغيره لاشتدت العقوبات والمثلات ، ولما بقي على ظهر الأرض أحد من هذا الخلق الذاكر لنفسه أشد الذكر الغافل عن ربه، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ *
عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ([96]).
وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾([97])، فربّ محمد (ص) وواهبه الكمال هو الرحمن، أي إنّ الرحمن هو باب الذات الذي يفاض منه الكمال على محمد (ص).
وقال تعالى: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ([98])، فخص هذين الاسمين بالذكر؛ لأن الفيض منهما، فالأول - أي الله - جامع لكمالات الذات، والثاني باب الذات.
ولما كان ظهور الذات في عالم الخلق هو علي (ع) فلا تعجب من قوله (ع) : (أنا مقدر الأفلاك ، ومكوكب النجوم في السماوات، ومن بينهما بإذن الله تعالى وعليتها بقدرته وسميتها الراقصات ولقبتها الساعات، وكورت الشمس وأطلقتها ونورتها، وجعلت البحار تجري بقدرة الله وأنا لها أهل. فقال ابن قدامة: يا أمير المؤمنين لولا أنك أتممت الكلام لقلنا لا اله إلا أنت، فقال أمير المؤمنين (ع): يا بن قدامة لا تتعجب تهلك بما تسمع، نحن مربوبون لا أرباب نكحنا النساء وحملتنا الأرحام وحملتنا الأصلاب، وعلمنا ما كان وما يكون وما في السماوات والأرضين بعلم ربنا، نحن المدبرون فنحن بذلك مخصوصون، ونحن عالمون) ([99]).
فبعلي يدبر عالم الخلق (عالم الإمكان)، فهو تجلي اسم الرحمن، وهو الباب الذي يخرج منه ما في المدينة - محمد (ص) - إلى سوها.
وبقي أنّ الكتاب يمكن أن يطلق على القرآن الكريم، فمحمد (ص) وعلي (ع) هما القرآن الناطق ([100])، والقرآن الكريم ليس سوى صورة أخرى لمحمد (ص).
﴿لا رَيْبَ فِيه﴾: الريب: يعني قلق النفس وخوفها وعدم اطمئنانها، وهو من لوازم الشك ولذلك يستعار للشك أحياناً وخصوصاً الشك العقائدي، فهو مما يستلزم قلق النفس وعدم اطمئنانها وخوفها من العاقبة.
والمعنى: إما أنه من يطلب الحق لا يشك في الكتاب، أي في محمد وعلي وفاطمة والأئمة والقرآن. وإما أنه نفس الكتاب لا شك فيه، أي نفس محمد (ص) هي نفس مطمئنة مستيقنة، وكذلك علي وفاطمة والأئمة (ع).
وكلا المعنيين صحيحين، وهذا المعنى الأخير يتضمن المعنى الأول. أما بيان هذه الصفة ([101]) المهمة للكتاب فهو ضروري؛ ليوصف أنه هدى لغيره.
﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾: لما كان الكتاب وهو (محمد (ص) والأئمة) مطمئن ومستيقن بالله وبالرسالة المكلف بأدائها، ولما كان مهدي إلى الحق، كان بالنسبة لغيره هادياً وهدى وعَلَماً يُستدل به على الطريق، ولكن مَنْ هذا الغير؟
فهل لأنه (ص) نور وحق ويقين وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل لأنه عَلَمٌ منصوب للجميع يكون هادياً للجميع المؤمن والفاسق والمنافق …؟ طبعاً لا؛ لأن ما يلزم الهداية إلى الحق أمران:
الأول: هو نَصبُ عَلَمٍ هادٍ ونور يستضاء به، وهذا هو المهدي الهادي النبي أو الإمام.
والثاني: كون فطرة الإنسان سليمة ليهتدي إلى هذا النور ويستضيء به، فالذين لوّثوا الفطرة التي فطرهم الله عليها كيف يهتدون؟ ولو التحقوا بهذا النور واقتربوا منه لم ينفعهم هذا الاقتراب لأنهم لا يبصرون، فستكون عاقبتهم الابتعاد. وبهذا فالكتاب أو الرسول أو الإمام هدىً لأصحاب اليقين، لأن التقوى من لوازم اليقين.
والسؤال هنا: مَنْ هؤلاء المتقون في زمن رسول الله أي عند بعثه؟ مع أنّ التقوى لا تأتي إلا بعد الإيمان، بل ودرجة عالية منه هي اليقين. ولماذا لم يقل: هدىً للمؤمنين، أو للموقنين؟ ثم إنّ محمداً (ص) والقرآن هدىً لجميع الناس، والدعوة للإسلام عامة ، فما معنى التخصيص؟ ثم هل يمكن أن تكون التقوى لباس الحنفي، أو اليهودي أو المسيحي قبل أن يسلم ليوصف بها؟
والجواب هنا: إنّ هؤلاء المتقين هم بعض الأحناف واليهود والمسيح في زمن الرسول (ص)، فهذه الديانات الثلاث هي التي كان بعض أفرادها يتصفون بأنهم يقيمون الصلاة ويدفعون الزكاة للفقراء، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ ([102]).
ثم إنّ الآيات بيَّنت حالهم بأنهم يؤمنون بما أنزل من قبل الرسول، أي إنهم أصحاب الديانات السماوية. ثم إنّ المتقين في زمن الإمام المهدي (ع) هم بعض المسلمين، وهكذا الأئمة (ع) إلى الإمام المهدي (ع). ومن هنا ففي زمننا مثلاً الإيمان بل واليقين بأهل بيت النبوة لا يكفي ليُوفق الإنسان لإتباع الإمام المهدي (ع) ويكون معه في الصف الأول أو الثاني، أعني الثلاث مائة والثلاث عشر أو العشرة آلاف، بل لابد من العمل بالشريعة الإسلامية، بل والإخلاص بالعمل لوجه الله ليكون الفرد المسلم المؤمن متقياً، ويكون الإمام المهدي هدى له ولإخوانه، فالآيات تُبيّن حال النخبة من المؤمنين بعلم الهدى والكتاب في زمانهم، وليس جميع المؤمنين بالرسول.
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ([103]). الإيمان هو التصديق، ولكن ما المراد بـ (الغيب) هنا؟
ربما للإجابة سنسطر قائمة طويلة، ولن نحصي الغيب قطعاً، وباختصار أقول: إنّ عالمي الملكوت والعقل هما الغيب الأصغر، وعالمي اللاهوت - أو الذات والحقيقة أو الكنه - هما الغيب الأكبر.
والغيب الأصغر يمكن أن يكشف بعضه لخاصة من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما كشف لإبراهيم (ع)، (لنريه ملكوت السماوات والأرض)، بل ويكشف لمن سلك طريق الله سبحانه وتعالى وإن كانت عاقبته الانحراف كالسامري: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ ([104])، وكبلعـم بن باعوراء: ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ ([105])، وروي أنه كان يرى ما تحت العرش ([106]).
أما الغيب الأكبر، فينقسم إلى: الغيب العظيم أو العلي، والغيب الأعظم أو الأعلى، وهما اللذان في تسبيح الصلاة في الركوع والسجود.
والغيب العظيم لم يكشف منه شيء إلا للنبي الكريم، ولهذا خوطب بأنه على خلق عظيم ([107])، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ([108]). ومرَّ ([109]) الحديث عن الإمام الصادق (ع) في كشف الحجاب للرسول الأعظم خاصة، وهو الحجاب الذي لم يكشف لأمير المؤمنين (ع)، فقال ما معناه: (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً) ([110]).
أما الغيب الأعلى أو الأعظم فهو المحجوب عن الكل، وحجابه الذات أو الأسماء الحسنى.
ومن هنا فالإيمان بهذه العوالم أي: الملكوت والعقل والذات والحقيقة، هو الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان على درجات أوضحها باختصار بهذا المثال: افرض أن حريقاً شب على بعد خمسة كيلو مترات عن مكان تواجدك فأنت تُحاط به علماً بإحدى الطرق التالية:
1- ينقل لك ثقاة صادقون خبر الحريق.
2- تذهب وترى الحريق بعينك.
3- تذهب وترى وتضع يدك في النار وتحترق يدك.
4- تقع في النار وتحترق حتى تصبح ناراً فتكون أنت من النار.
وربما يتسرع إنسان ويقول: إنّ العلم الحاصل من شهادة خمسين شخصاً ثقاة لا يكذبون هو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار بالعين، وهو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار واحتراق اليد.
وهذا اشتباه؛ لأن العلم الأول يمكن أن ينقض إذا شهد لك خمسون من الثقاة بأنه لا يوجد حريق، والثاني يمكن أن ينقض إذا شككت أنّ هذا الحريق هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون، الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم. أما الثالث فهو ثابت لا ينقض لوجود أثر النار في يدك، والقلب يكون مطمئناً.
قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ ([111])، فإبراهيم (ع) طلب هذه الدرجة من الإيمان، ولذلك قال تعالى بعدها: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ([112]).
أما الرابع الذي عبرت عنه بأنه يحترق في النار حتى يصبح هو ناراً، فهذا لم يتحقق إلا لمحمد (ص) الإنسان. وهو فقط من كشف له الحجاب فكان قاب قوسين أو أدنى، وأصبح هو صلوات الله عليه وعلى آله حجاب الذات، ومن كشف له الغيب العظيم، أو بعبارة أخرى الذات أو قل: الكمالات الإلهية المشار إليها بكلمة الله.
وفي الحديث عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى (ع)، قال: قلت له لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأي علة يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
قال: (يا هشام، إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فلما أسرى بالنبي (ص) وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول الله (ص)، وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبر ، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب وكبر سبع تكبيرات. فلما ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فلما قال سبع مرات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنة) ([113]).
والحمد لله وحده
سورة الكوثر .... وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
--------
الخطبة الثانية
--------
الحَمْدُ للهِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ يَبْقى رَبُّنا وَيَفْنى كُلُّ أَحَدٍ، وَالحَمْدُ للهِ أَبَدَ الأبَدِ وَمَعَ الأبَدِ مِمّا لا يُحْصِيهِ العَدَدُ وَلا يُفْنِيهِ الأمَدُ وَلا يَقْطَعُهُ الأبَدُ، وَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الخالِقِينَ.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلى علي المرتضى، وعلى فاطمة الزهراء، وعلى الحسن الزكي، وعلى الحسين الشهيد، وعلى التسعة المعصومين من ولد الحسين؛ السجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والحجة الخلف القائم المهدي، اللهم وصل على أول المهديين أحمد الحسن، والأحدى عشر مهدياً من ولده صلاة كثيرة دائمة. اللهم مكن لهم في الأرض وزين الأرض بطول بقائهم، اللهم زد في أعمارهم وآجالهم وبلغهم أقصى ما يأملون ديناً ودنياً وآخره إنك على كل شي قدير.
نستكمل حديثنا إن شاء الله ...
﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: إقامة الصلاة أي التوجه بها إلى الله، وبخشوع وحضور قلبي. والإنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، وربما كان ذكر هاتين العبادتين وإغفال ما سواهما فيه بيان فضلهما، فالأحناف كانوا يحجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية المسلمين اليوم ([114])، بل تكاد تكون هي نفسها، ولكن الحج كان فارغاً من محتواه وهو الولاية لولي الله وحجته على خلقه، واليهود والمسيح كانوا يصومون، والله أعلم.
وهذا الوصف للمتقين كلٌ بحسبه، ففي زمن الرسول للمتقي الحنفي صلاته، وللمتقي اليهودي صلاته، وللمتقي المسيحي صلاته. وربما يعترض أحد ويقول: إنّ هذه الديانات في زمن الرسول محرفة عقائدياً فضلاً عن الأحكام الشرعية وتفاصيل العبادات، فهي ليست كما جاء بها من أرسل بها، أعني إبراهيم وموسى وعيسى (ع)؟
وأقول: إنّ هؤلاء المتقين موجودون في كل ديانة في زمن الرسول (ص) رغم التحريف، فهم قد جانبوا هذا التحريف كما ورد عن الرسول (ص) في حق جده عبد المطلب ([115])، ولا أقل أنهم التزموا جانب الاحتياط، فلم يقدسوا تماثيل قريش التي ابتدعوها، ولم يحرموا البحيرة والحام والسائبة، ولم يعملوا بالنسيء، ولم يعتقدوا بأنّ عيسى إله، ولم يحرموا ما أحل الله، ولم يحلوا ما حرم الله.
وهؤلاء هم أصحاب محمد (ص) الذين مدحوا في القرآن في آخر سورة الفتح ([116])، ومنهم من آمن بمجرد رؤية الرسول (ص)، ومنهم من آمن بمجرد سماع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع لما عرفوا أنه الحق من ربهم. هؤلاء كانوا على علاقة بربهم قبل أن يبعث محمد (ص) فلم يطلبوا منه معجزة أو آية، بل طلبوا من ربهم أن يعرفهم أمر محمد (ص) فعرفهم، ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾([117])، أولئك على هدى من ربهم فزادهم ربهم هدى بمحمد (ص)وبالقرآن.
واليوم عادت مصيبة المسلمين كيوم بعث رسول الله (ص)، فالانحراف في العقائد قد طال معظم فرق المسلمين. أما الانحراف في الأحكام ([118]) فأقولها وبلا تردد: قد طال جميع فرق المسلمين وبلا استثناء، بل ويقولها معي كل باحث حر كسر قيود التقليد الأعمى، ووضع قدمه على (الأنا) و(الهوى) وأخذ العلم من أهله؛ النبي وآله (ع)، فلم يتجاوز القرآن والحديث الذي ورد عنهم (ع)، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة - وهي في الحقيقة ظل العقل ([119]) ويسميها الناس العقل - لإدراك المعاني التي أرادها سبحانه وأرادوها (ع)، وأن يحذر من المتشابه - وما أكثره - كل الحذر؛ لئّلا تتقاذفه أمواج الهوى والأنا والشيطان.
﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ([120]): وهذا الوصف، أي: (يؤمنون بما أُنزل من قبلك) يؤكد أنّ المتقين الذين نصب لهم محمد (ص) كعلم وهادٍ - وهم مؤهلون للإيمان به - ليس إلا المؤمنين بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونصارى، ووصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل للرسول؛ لأن الكلام عن حالهم وهم يشاهدون الكتاب فيكون بالنسبة لهم هدى، فهم في حال شروع بالإسلام والإيمان بالرسول، فهم على هدى من ربهم فزادهم هدى بمحمد (ص).
وهؤلاء مصداق أول للآية، وإلا فالآية حية بحياة القرآن الذي يشمل جميع الأزمنة إلى أن تقوم الساعة ([121])، ففي هذا الزمان مثلاً الإيمان بالمهدي (ع) وعيسى وإلياس والخضر هو الإيمان بما أُنزل للرسول وما أُنزل من قبله؛ لأن المهدي (ع) مما أُنزل إلى الرسول، وعيسى وإلياس والخضر مما أُنزل قبله، فهم (ع) الغيب في الآية السابقة وما أُنزل في هذه الآية.
﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾: اليقين غالباً يأتي من المشاهدة، فهؤلاء قد شاهدوا شيئاً من الآخرة وهم في الدنيا، بعد أن كشف لهم الغطاء - طبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمير المؤمنين (ع) والذي لم يكشف إلا للرسول (ص) - إثر مجاهدة أنفسهم وطاعة خالقهم، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ([122]).
وقال إمام المتقين الموقنين: (وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه ، بمنزلة الأدلة في الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات. وإن للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا على غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون …) ([123]).
ومن هنا يتبين أنّ هذا الوصف لخاصة من المؤمنين بالرسالات السماوية عموماً، ورسالة محمد (ص) خصوصاً. ولم يرَ تاريخ الإسلام إلا أفراداً قلائل منهم، وإلا فمعظمهم هم أصحاب المهدي الثلاث مائة وثلاث عشر، ثم الخط الثاني الذي يتبعهم وهم العشرة آلاف؛ أنصار الإمام (ع).
﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: وهذا الهدى سابق لحالة الإيمان بالرسالة الجديدة، فهم على هدى من ربهم؛ لأنهم أطاعوه. هؤلاء أصحاب أسرار مع ربهم ولهم حالات مع خالقهم، ولذلك كما قدمت لم يحتاجوا إلى معجزة، بل مجرد رؤية الرسول أو سماع شيء من القرآن آمنوا؛ لأنهم على هدى من ربهم ، فالذي عرَّفهم بأنّ محمداً (ص) صادقٌ ومرسلٌ هو الله الذي أرسل محمداً (ص)، وكمثال لهؤلاء من أصحاب محمد (ص) هو سلمان الفارسي وقد كان نصرانياً، والحمد لله وحده.
والصلاة والسلام على المحمود الأحمد، والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ...
سؤال/ 45: ما معنى قوله تعالى في أول سورة البقرة: ﴿ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب﴾ ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿آلم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ([87]).
اسم الله: هو مدينة الكمالات التي أشرقت وتجلت من حقيقته وهويته سبحانه التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كما أن الرحمن الرحيم وهما متحدان في المعنى يمثلان باب هذه المدينة، وظل هذه المدينـة في عالم الممكنات هو الذي أشرقت في ذاته وتجلت فيه وهو محمد (ص)، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ([88])؛ لأنه تخلق بأخلاق الله، وإلا فلا يستحق خُلق أن يوصف بأنه عظيم إلا إذا كان تجلّياً وظهّوراً لأخلاق الله سبحانه وتعالى، ومن هنا كان محمد (ص) مدينة العلم.
أما باب هذه المدينة فهو علي (ع) ومن اختلط لحمها بلحمه ودمها بدمه فاطمة (ع)، وبهذا فعلي (ع) تجلي للرحمن، وفاطمة (ع) تجلي للرحيم، وهما متحدان كاتحاد الرحمن الرحيم ومفترقان كافتراق الرحمن الرحيم.
﴿أ ل م﴾: قال أمير المؤمنين (ع): (أنا: ح الحواميم، أنا: قسم أ ل م … أنا: ترجمة ص … أنا: ن والقلم) ([89]). وهذه الحروف هي أسماء أهل البيت (ع)، وهنا (م) محمد، و (ل) علي، و (أ) فاطمة وإذا حسبت عدد هذه الحروف وجدتها أربعة عشر على عددهم (ع). وتكرر الميم (17) مرة، واللام (13) مرة، والألف (13) مرة.
ومن هذه الحروف تألف القرآن، وهم (ع) القرآن ([90]). ومن هذه الحروف يؤلف الاسم الأعظم كما روي عنهم (ع) ([91])، وهم الاسم الأعظم كما روي عنهم (ع) أيضاً ([92])، أي تجلي الاسم الأعظم، وما يمكن أن يعرف من الاسم الأعظم، أو قل الاسم الأعظم في عالم الخلق (الممكنات).
وكما أنّ الكتابة تتألف من اختلاط هذه الحروف الأربعة عشر النورانية مع الأربعة عشر الأخرى الظلمانية، كذلك وجود المخلوق (الممكن) يتألف من اختلاط نورهم بالظلمات، أو قل: تجلي أنوارهم في الظلمات.
كما أنهم (ع) يمثلون تجلي نور الله سبحانه وتعالى في الظلمة، وأعني بالظلمة العدم القابل للوجود، قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور ٍ﴾ ([93]). فهم (ع) مَثَل نور الله ([94]).
﴿ذَلِكَ الْكِتَاب﴾: ذلك : اسم إشارة للبعيد، وهو هنا إشارة إلى الحروف: (ا ل م) القريبة، فالبعد المراد هنا ليس مكاني بل شأني، فهذه الأسماء المباركة والتي هي كتاب الله أيضاً عالية الشأن رفيعة الدرجة والمقام لا تنال، قال (ص) ما معناه: (يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا) ([95]).
والكتاب: أي كتاب الله الحاوي للعلم وهو محمد (ص) أو الميم، وهو علي أو اللام، وهو فاطمة أو الألف.
ومحمد (ص) هو الكتاب الأتم والكلمة التامة، والأولى بأن يطلق كتاب الله عليه، فالموجودات جميعها منطوية في صفحة وجوده المباركة ومكتوبة فيه، كالكلمات المكتوبة في السجل.
وهو صلوات الله عليه في عالم الخلق الألف والياء، والبداية والنهاية، والظاهر والباطن. وكذلك علي وفاطمة، ولكنه صلوات الله عليه كتاب بلا حجاب، وهما صلوات الله عليهما محجوبان به (ص)عن الذات. فهو المدينة وهما الباب المواجه للخلق ، ومنهما يؤخذ ، ومنهما يفاض على الخلق.
أما الباب الآخر للمدينة والكتاب المواجه للذات الإلهية فهو الرحمن، وبهذا الباب العظيم الرحمة افتتح عالم الخلق أو كما يسميه بعضهم عالم الإمكان، وببركته خلق الإنس والملائكة والجان، وبه يعلمون وبه يرزقون وبه يدبر الأمر، ولو دبر بغيره لاشتدت العقوبات والمثلات ، ولما بقي على ظهر الأرض أحد من هذا الخلق الذاكر لنفسه أشد الذكر الغافل عن ربه، قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ *
عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ ([96]).
وقال تعالى: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾([97])، فربّ محمد (ص) وواهبه الكمال هو الرحمن، أي إنّ الرحمن هو باب الذات الذي يفاض منه الكمال على محمد (ص).
وقال تعالى: ﴿ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ([98])، فخص هذين الاسمين بالذكر؛ لأن الفيض منهما، فالأول - أي الله - جامع لكمالات الذات، والثاني باب الذات.
ولما كان ظهور الذات في عالم الخلق هو علي (ع) فلا تعجب من قوله (ع) : (أنا مقدر الأفلاك ، ومكوكب النجوم في السماوات، ومن بينهما بإذن الله تعالى وعليتها بقدرته وسميتها الراقصات ولقبتها الساعات، وكورت الشمس وأطلقتها ونورتها، وجعلت البحار تجري بقدرة الله وأنا لها أهل. فقال ابن قدامة: يا أمير المؤمنين لولا أنك أتممت الكلام لقلنا لا اله إلا أنت، فقال أمير المؤمنين (ع): يا بن قدامة لا تتعجب تهلك بما تسمع، نحن مربوبون لا أرباب نكحنا النساء وحملتنا الأرحام وحملتنا الأصلاب، وعلمنا ما كان وما يكون وما في السماوات والأرضين بعلم ربنا، نحن المدبرون فنحن بذلك مخصوصون، ونحن عالمون) ([99]).
فبعلي يدبر عالم الخلق (عالم الإمكان)، فهو تجلي اسم الرحمن، وهو الباب الذي يخرج منه ما في المدينة - محمد (ص) - إلى سوها.
وبقي أنّ الكتاب يمكن أن يطلق على القرآن الكريم، فمحمد (ص) وعلي (ع) هما القرآن الناطق ([100])، والقرآن الكريم ليس سوى صورة أخرى لمحمد (ص).
﴿لا رَيْبَ فِيه﴾: الريب: يعني قلق النفس وخوفها وعدم اطمئنانها، وهو من لوازم الشك ولذلك يستعار للشك أحياناً وخصوصاً الشك العقائدي، فهو مما يستلزم قلق النفس وعدم اطمئنانها وخوفها من العاقبة.
والمعنى: إما أنه من يطلب الحق لا يشك في الكتاب، أي في محمد وعلي وفاطمة والأئمة والقرآن. وإما أنه نفس الكتاب لا شك فيه، أي نفس محمد (ص) هي نفس مطمئنة مستيقنة، وكذلك علي وفاطمة والأئمة (ع).
وكلا المعنيين صحيحين، وهذا المعنى الأخير يتضمن المعنى الأول. أما بيان هذه الصفة ([101]) المهمة للكتاب فهو ضروري؛ ليوصف أنه هدى لغيره.
﴿هُدىً لِلْمُتَّقِينَ﴾: لما كان الكتاب وهو (محمد (ص) والأئمة) مطمئن ومستيقن بالله وبالرسالة المكلف بأدائها، ولما كان مهدي إلى الحق، كان بالنسبة لغيره هادياً وهدى وعَلَماً يُستدل به على الطريق، ولكن مَنْ هذا الغير؟
فهل لأنه (ص) نور وحق ويقين وتقوى يكون هادياً للجميع؟ وهل لأنه عَلَمٌ منصوب للجميع يكون هادياً للجميع المؤمن والفاسق والمنافق …؟ طبعاً لا؛ لأن ما يلزم الهداية إلى الحق أمران:
الأول: هو نَصبُ عَلَمٍ هادٍ ونور يستضاء به، وهذا هو المهدي الهادي النبي أو الإمام.
والثاني: كون فطرة الإنسان سليمة ليهتدي إلى هذا النور ويستضيء به، فالذين لوّثوا الفطرة التي فطرهم الله عليها كيف يهتدون؟ ولو التحقوا بهذا النور واقتربوا منه لم ينفعهم هذا الاقتراب لأنهم لا يبصرون، فستكون عاقبتهم الابتعاد. وبهذا فالكتاب أو الرسول أو الإمام هدىً لأصحاب اليقين، لأن التقوى من لوازم اليقين.
والسؤال هنا: مَنْ هؤلاء المتقون في زمن رسول الله أي عند بعثه؟ مع أنّ التقوى لا تأتي إلا بعد الإيمان، بل ودرجة عالية منه هي اليقين. ولماذا لم يقل: هدىً للمؤمنين، أو للموقنين؟ ثم إنّ محمداً (ص) والقرآن هدىً لجميع الناس، والدعوة للإسلام عامة ، فما معنى التخصيص؟ ثم هل يمكن أن تكون التقوى لباس الحنفي، أو اليهودي أو المسيحي قبل أن يسلم ليوصف بها؟
والجواب هنا: إنّ هؤلاء المتقين هم بعض الأحناف واليهود والمسيح في زمن الرسول (ص)، فهذه الديانات الثلاث هي التي كان بعض أفرادها يتصفون بأنهم يقيمون الصلاة ويدفعون الزكاة للفقراء، قال تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ﴾ ([102]).
ثم إنّ الآيات بيَّنت حالهم بأنهم يؤمنون بما أنزل من قبل الرسول، أي إنهم أصحاب الديانات السماوية. ثم إنّ المتقين في زمن الإمام المهدي (ع) هم بعض المسلمين، وهكذا الأئمة (ع) إلى الإمام المهدي (ع). ومن هنا ففي زمننا مثلاً الإيمان بل واليقين بأهل بيت النبوة لا يكفي ليُوفق الإنسان لإتباع الإمام المهدي (ع) ويكون معه في الصف الأول أو الثاني، أعني الثلاث مائة والثلاث عشر أو العشرة آلاف، بل لابد من العمل بالشريعة الإسلامية، بل والإخلاص بالعمل لوجه الله ليكون الفرد المسلم المؤمن متقياً، ويكون الإمام المهدي هدى له ولإخوانه، فالآيات تُبيّن حال النخبة من المؤمنين بعلم الهدى والكتاب في زمانهم، وليس جميع المؤمنين بالرسول.
﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ([103]). الإيمان هو التصديق، ولكن ما المراد بـ (الغيب) هنا؟
ربما للإجابة سنسطر قائمة طويلة، ولن نحصي الغيب قطعاً، وباختصار أقول: إنّ عالمي الملكوت والعقل هما الغيب الأصغر، وعالمي اللاهوت - أو الذات والحقيقة أو الكنه - هما الغيب الأكبر.
والغيب الأصغر يمكن أن يكشف بعضه لخاصة من أولياء الله سبحانه وتعالى، كما كشف لإبراهيم (ع)، (لنريه ملكوت السماوات والأرض)، بل ويكشف لمن سلك طريق الله سبحانه وتعالى وإن كانت عاقبته الانحراف كالسامري: ﴿بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ ([104])، وكبلعـم بن باعوراء: ﴿آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا﴾ ([105])، وروي أنه كان يرى ما تحت العرش ([106]).
أما الغيب الأكبر، فينقسم إلى: الغيب العظيم أو العلي، والغيب الأعظم أو الأعلى، وهما اللذان في تسبيح الصلاة في الركوع والسجود.
والغيب العظيم لم يكشف منه شيء إلا للنبي الكريم، ولهذا خوطب بأنه على خلق عظيم ([107])، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى ([108]). ومرَّ ([109]) الحديث عن الإمام الصادق (ع) في كشف الحجاب للرسول الأعظم خاصة، وهو الحجاب الذي لم يكشف لأمير المؤمنين (ع)، فقال ما معناه: (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً) ([110]).
أما الغيب الأعلى أو الأعظم فهو المحجوب عن الكل، وحجابه الذات أو الأسماء الحسنى.
ومن هنا فالإيمان بهذه العوالم أي: الملكوت والعقل والذات والحقيقة، هو الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان على درجات أوضحها باختصار بهذا المثال: افرض أن حريقاً شب على بعد خمسة كيلو مترات عن مكان تواجدك فأنت تُحاط به علماً بإحدى الطرق التالية:
1- ينقل لك ثقاة صادقون خبر الحريق.
2- تذهب وترى الحريق بعينك.
3- تذهب وترى وتضع يدك في النار وتحترق يدك.
4- تقع في النار وتحترق حتى تصبح ناراً فتكون أنت من النار.
وربما يتسرع إنسان ويقول: إنّ العلم الحاصل من شهادة خمسين شخصاً ثقاة لا يكذبون هو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار بالعين، وهو نفسه العلم الحاصل من رؤية النار واحتراق اليد.
وهذا اشتباه؛ لأن العلم الأول يمكن أن ينقض إذا شهد لك خمسون من الثقاة بأنه لا يوجد حريق، والثاني يمكن أن ينقض إذا شككت أنّ هذا الحريق هو سحر عظيم كسحر سحرة فرعون، الذين استرهبوا الناس وسحروا أعينهم. أما الثالث فهو ثابت لا ينقض لوجود أثر النار في يدك، والقلب يكون مطمئناً.
قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ ([111])، فإبراهيم (ع) طلب هذه الدرجة من الإيمان، ولذلك قال تعالى بعدها: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ([112]).
أما الرابع الذي عبرت عنه بأنه يحترق في النار حتى يصبح هو ناراً، فهذا لم يتحقق إلا لمحمد (ص) الإنسان. وهو فقط من كشف له الحجاب فكان قاب قوسين أو أدنى، وأصبح هو صلوات الله عليه وعلى آله حجاب الذات، ومن كشف له الغيب العظيم، أو بعبارة أخرى الذات أو قل: الكمالات الإلهية المشار إليها بكلمة الله.
وفي الحديث عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن موسى (ع)، قال: قلت له لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل؟ ولأي علة يقال في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده؟ ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده؟
قال: (يا هشام، إن الله تبارك وتعالى خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً، فلما أسرى بالنبي (ص) وكان من ربه كقاب قوسين أو أدنى، رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول الله (ص)، وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح، فلما رفع له الثاني كبر ، فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب وكبر سبع تكبيرات. فلما ذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع خرّ على وجهه يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده. فلما قال سبع مرات سكن ذلك الرعب، فلذلك جرت به السنة) ([113]).
والحمد لله وحده
سورة الكوثر .... وصلى الله على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا.
--------
الخطبة الثانية
--------
الحَمْدُ للهِ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ بَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَالحَمْدُ للهِ يَبْقى رَبُّنا وَيَفْنى كُلُّ أَحَدٍ، وَالحَمْدُ للهِ أَبَدَ الأبَدِ وَمَعَ الأبَدِ مِمّا لا يُحْصِيهِ العَدَدُ وَلا يُفْنِيهِ الأمَدُ وَلا يَقْطَعُهُ الأبَدُ، وَتَبارَكَ الله أَحْسَنُ الخالِقِينَ.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين. اللهم صل على محمد المصطفى، وعلى علي المرتضى، وعلى فاطمة الزهراء، وعلى الحسن الزكي، وعلى الحسين الشهيد، وعلى التسعة المعصومين من ولد الحسين؛ السجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والتقي محمد، والنقي علي، والزكي العسكري، والحجة الخلف القائم المهدي، اللهم وصل على أول المهديين أحمد الحسن، والأحدى عشر مهدياً من ولده صلاة كثيرة دائمة. اللهم مكن لهم في الأرض وزين الأرض بطول بقائهم، اللهم زد في أعمارهم وآجالهم وبلغهم أقصى ما يأملون ديناً ودنياً وآخره إنك على كل شي قدير.
نستكمل حديثنا إن شاء الله ...
﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾: إقامة الصلاة أي التوجه بها إلى الله، وبخشوع وحضور قلبي. والإنفاق هنا يشمل الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، وربما كان ذكر هاتين العبادتين وإغفال ما سواهما فيه بيان فضلهما، فالأحناف كانوا يحجون ويلبون بتلبية قريبة من تلبية المسلمين اليوم ([114])، بل تكاد تكون هي نفسها، ولكن الحج كان فارغاً من محتواه وهو الولاية لولي الله وحجته على خلقه، واليهود والمسيح كانوا يصومون، والله أعلم.
وهذا الوصف للمتقين كلٌ بحسبه، ففي زمن الرسول للمتقي الحنفي صلاته، وللمتقي اليهودي صلاته، وللمتقي المسيحي صلاته. وربما يعترض أحد ويقول: إنّ هذه الديانات في زمن الرسول محرفة عقائدياً فضلاً عن الأحكام الشرعية وتفاصيل العبادات، فهي ليست كما جاء بها من أرسل بها، أعني إبراهيم وموسى وعيسى (ع)؟
وأقول: إنّ هؤلاء المتقين موجودون في كل ديانة في زمن الرسول (ص) رغم التحريف، فهم قد جانبوا هذا التحريف كما ورد عن الرسول (ص) في حق جده عبد المطلب ([115])، ولا أقل أنهم التزموا جانب الاحتياط، فلم يقدسوا تماثيل قريش التي ابتدعوها، ولم يحرموا البحيرة والحام والسائبة، ولم يعملوا بالنسيء، ولم يعتقدوا بأنّ عيسى إله، ولم يحرموا ما أحل الله، ولم يحلوا ما حرم الله.
وهؤلاء هم أصحاب محمد (ص) الذين مدحوا في القرآن في آخر سورة الفتح ([116])، ومنهم من آمن بمجرد رؤية الرسول (ص)، ومنهم من آمن بمجرد سماع آيات القرآن وفاضت أعينهم من الدمع لما عرفوا أنه الحق من ربهم. هؤلاء كانوا على علاقة بربهم قبل أن يبعث محمد (ص) فلم يطلبوا منه معجزة أو آية، بل طلبوا من ربهم أن يعرفهم أمر محمد (ص) فعرفهم، ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾([117])، أولئك على هدى من ربهم فزادهم ربهم هدى بمحمد (ص)وبالقرآن.
واليوم عادت مصيبة المسلمين كيوم بعث رسول الله (ص)، فالانحراف في العقائد قد طال معظم فرق المسلمين. أما الانحراف في الأحكام ([118]) فأقولها وبلا تردد: قد طال جميع فرق المسلمين وبلا استثناء، بل ويقولها معي كل باحث حر كسر قيود التقليد الأعمى، ووضع قدمه على (الأنا) و(الهوى) وأخذ العلم من أهله؛ النبي وآله (ع)، فلم يتجاوز القرآن والحديث الذي ورد عنهم (ع)، مستعيناً بربه وما وهبه من قوة ناطقة - وهي في الحقيقة ظل العقل ([119]) ويسميها الناس العقل - لإدراك المعاني التي أرادها سبحانه وأرادوها (ع)، وأن يحذر من المتشابه - وما أكثره - كل الحذر؛ لئّلا تتقاذفه أمواج الهوى والأنا والشيطان.
﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ([120]): وهذا الوصف، أي: (يؤمنون بما أُنزل من قبلك) يؤكد أنّ المتقين الذين نصب لهم محمد (ص) كعلم وهادٍ - وهم مؤهلون للإيمان به - ليس إلا المؤمنين بالنبوات السابقة من أحناف ويهود ونصارى، ووصفهم بأنهم يؤمنون بما أنزل للرسول؛ لأن الكلام عن حالهم وهم يشاهدون الكتاب فيكون بالنسبة لهم هدى، فهم في حال شروع بالإسلام والإيمان بالرسول، فهم على هدى من ربهم فزادهم هدى بمحمد (ص).
وهؤلاء مصداق أول للآية، وإلا فالآية حية بحياة القرآن الذي يشمل جميع الأزمنة إلى أن تقوم الساعة ([121])، ففي هذا الزمان مثلاً الإيمان بالمهدي (ع) وعيسى وإلياس والخضر هو الإيمان بما أُنزل للرسول وما أُنزل من قبله؛ لأن المهدي (ع) مما أُنزل إلى الرسول، وعيسى وإلياس والخضر مما أُنزل قبله، فهم (ع) الغيب في الآية السابقة وما أُنزل في هذه الآية.
﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾: اليقين غالباً يأتي من المشاهدة، فهؤلاء قد شاهدوا شيئاً من الآخرة وهم في الدنيا، بعد أن كشف لهم الغطاء - طبعاً ليس الغطاء الذي قصده أمير المؤمنين (ع) والذي لم يكشف إلا للرسول (ص) - إثر مجاهدة أنفسهم وطاعة خالقهم، قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ([122]).
وقال إمام المتقين الموقنين: (وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة، يذكرون بأيام الله ويخوفون مقامه ، بمنزلة الأدلة في الفلوات، من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبشروه بالنجاة، ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة، وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات. وإن للذكر لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه يقطعون به أيام الحياة، ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين، ويأمرون بالقسط ويأتمرون به، وينهون عن المنكر ويتناهون عنه، فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك، فكأنما اطلعوا على غيوب أهل البرزخ في طول الإقامة فيه، وحققت القيامة عليهم عداتها فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس ويسمعون ما لا يسمعون …) ([123]).
ومن هنا يتبين أنّ هذا الوصف لخاصة من المؤمنين بالرسالات السماوية عموماً، ورسالة محمد (ص) خصوصاً. ولم يرَ تاريخ الإسلام إلا أفراداً قلائل منهم، وإلا فمعظمهم هم أصحاب المهدي الثلاث مائة وثلاث عشر، ثم الخط الثاني الذي يتبعهم وهم العشرة آلاف؛ أنصار الإمام (ع).
﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾: وهذا الهدى سابق لحالة الإيمان بالرسالة الجديدة، فهم على هدى من ربهم؛ لأنهم أطاعوه. هؤلاء أصحاب أسرار مع ربهم ولهم حالات مع خالقهم، ولذلك كما قدمت لم يحتاجوا إلى معجزة، بل مجرد رؤية الرسول أو سماع شيء من القرآن آمنوا؛ لأنهم على هدى من ربهم ، فالذي عرَّفهم بأنّ محمداً (ص) صادقٌ ومرسلٌ هو الله الذي أرسل محمداً (ص)، وكمثال لهؤلاء من أصحاب محمد (ص) هو سلمان الفارسي وقد كان نصرانياً، والحمد لله وحده.


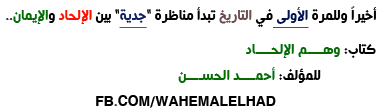
Comment